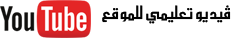نتعامل اليوم مع نتائج مروعة للأزمة السورية، حيث تبدو الحركات الجهادية الأكثر حضورا، ويظهر مشروعها وكأنه “خلاصات” للحدث السوري المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وبغض النظر عن التحليلات التي تتحدث عن “سرقة الثورة” أو اتهام النظام في مسألة “العسكرة”، فإننا نقف اليوم أمام شرعيتين: الأولى هي الدولة السورية بمقوماتها التي ظهرت مع الاستقلال، بكل ما حملته من توافق لإرادة السوريين، رغم عدم وجود ميثاق وطني، والثانية هي شرعية دولة “الجهاد” التي تمثلها تنظيمات مختلفة ابتداء من داعش ومرورا بالنصرة ووصولا إلى الجبهة الإسلامية، فكافة هذه التشكيلات لا تحمل معها مشروعا يتوافق مع دولة الاستقلال، بل تشكل لنفسها مرجعية مختلفة، وحتى “الجبهة الإسلامية” وفق تصريحات “زهران علوش” لا تختلف من حيث الأساس الفكري عن قاعدة الجهاد، وتستند إلى جذور فقهية فيها من التكفير ما يكفي لنسف أي مشروع لدولة تحمل تعددا دينيا وانفتاحا ثقافيا.
صورة للبدايات
تشكل الحدث السوري وتطور عبر أمرين أساسيين: الأول رفض النظام السياسي القائم، والثاني إيجاد مشروعية جديدة للدولة عبر جملة من الصيغ التي تم تداولها ما بين الأطراف السياسية على تباين توجهاتها، ورغم أن مسألة النظام السياسي طفت على إيقاع التغطية الإعلامية، إلا أن جملة من المؤشرات توحي بأن بنية الدولة كانت هدفا، وأن الاضطراب رسم ملامح انقلاب طال “دولة الاستقلال” ولم يكتف باستهداف ما يطلق عليه في أدبيات المعارضة بـ”دولة البعث” القائمة منذ عام 1963، فمسألة “الدولة” دخلت ضمن سياق عام للمنطقة برز فيها “صعود” للتيار الديني في تونس أولا عبر حركة النهضة، وفي مصر عبر حركة الأخوان المسلمين، ونحن نتحدث هنا عن سياق عام لأن الاحتواء الفكري لكل ما حدث جرى ضمن إطار رعاه “الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين” في قطر، فكانت تصريحات القرضاوي غطاء شرعيا، بينما وفر حزب العدالة والتنمية (يمثل تيارا دينيا) النموذج لديمقراطية إسلامية إن صح التعبير.
عمليا فإن “الموجة” الدينية شكلت صلب الاضطراب السوري، رغم الحديث عن حراك مدني، وعن “تنسيقيات” تدير “الحراك” على الأرض، فالعمق الحقيقي لتجميع “إرادة سورية معارضة” لم تظهر إلا عبر التنظيمات والشخصيات الدينية، فالمجلس الوطني أولا ثم الإئتلاف الوطني كان عماده حركة الأخوان المسلمين، والمتحدثون باسم “الحراك” على الفضائيات غالبيتهم يملكون “ايديدلوجيا” دينية، أما البيئة الاجتماعية التي احتضنت المسلحين لاحقا فهي وفق تاريخ سورية المعاصر مرتبطة بـ”الاسلام السياسي” عموما سواء في ريف إدلب أو بانياس أو حتى ريف حوران، مع التأكيد هنا أن ما انتشر هناك لا ينتمي بالمطلق إلى الاسلام السياسي العنيف الذي ظهر في سورية من أواسط الستينات عبر الطليعة المقاتلة للأخوان المسلمين، بل هو فكر منسجم بشكل عام مع التطورات الأخيرة للإسلام السياسي بعد الحرب الأفغانية وظهور تنظيم القاعدة، فهو جهادي بالدرجة الأولى ومشروعه ليس معاكسا للغرب “الاستعماري” بل لـ”الغرب الصليبي” وفق مصطلحات القاعدة، فهو يحارب الفكر الغربي أكثر من كونه يصارع السياسات الغربية، تماما كما فعلت الحركات الجهادية في أفغانستان خلال الحقبة السوفياتية.
وأعتقد أن التمييز هنا ضروري لفهم ظهور المشروع الجهادي في سورية، لأن شبكة تحالفات التشكيلات العسكرية، وحتى القيادات السياسية، كانت منذ البداية شبيهة بما ظهر في أفغانستان، وكان الغطاء السياسي يدفع ببعض الشخصيات إلى الواجهة، إلا أنه منذ تأسيس “الائتلاف الوطني” في الدوحة ظهر بوضوح أن حلفاء التمرد المسلح بسورية يفضلون الصيغة الأفغانية من خلال تأسيس توليفة قبلية – عسكرية ظهرت نتائجها بوضوح من خلال تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وصراعها مع جبهة النصرة.
شرعية غامضة
لا يمكن الرهان اليوم على مشروع دولة دينية في مواجهة دولة تملك حدودا دنيا من العلمانية متوافقة مع النسيج السوري، فحتى مؤتمر جنيف2 كان يسعى لمرحلة انتقالية وفق توجه المعارضة ومن ثم محاربة الارهاب، بينما كان توجه النظام أن تتم محاربة الارهاب أولا، وفي كلا الطرحين ينهار مفهوم الدولة الدينية من أجل البحث عن حلول سياسية لحركات الجهاد المتنامية داخل سورية، في المقابل فإن مشروع الاسلام المعتدل الذي دفعت تركيا بكل جهودها نحو تحقيقه في المنطقة ككل انهار تماما وبرزت خلافات تركية – مصرية حول هذا الموضوع، وفي اللحظة الراهنة هناك تحدي حول وجود الدولة (ليس في سورية فقط بل في المنطقة ككل) أو العودة لمراحل ما قبل الدولة وفق النموذج الأفغاني والصومالي وغيرها من مناطق التدخل الأمريكي العسكري المباشر.
خيارات محدودة واحتمالات مفتوحة
لا تعاني شرعية الدولة السورية اليوم من التآكل، فرغم المشكلة العميقة بين دمشق والعديد من العواصم الدولية، إلا أن التمسك الاجتماعي بالدولة يشكل عنوانا له عمقه داخل مصالح السوريين الذين يدركون أن الخيارات باتت محدودة وأن مسألة الاستبداد والكرامة التي طُرحت في بداية الأحداث لم تعد جوهر الأزمة الحالية؛ فهناك تحد أكبر في مسألة البقاء والاستمرار كدولة أو العودة نحو زمن الإمارات المتقاتلة، فانهيار الدولة السورية لا يعني نهاية النظام وفق المعطيات الحالية، وفي أفضل الحالات يمكن أن تتحول سورية إلى شكل شبيه بالدولة العراقية التي تتنازعها سلطات سياسية مختلفة ذات مرجعية أثنية أو دينية.
فالخيارات المتاحة على المستوى السياسي لا تملك تنوعا، فبينما تتجه المعارضة في الخارج إجمالا نحو “الدولة المرنة” وفق النموذج العراقي، الذي يعاني اليوم من تمزق وانهيارات، وبين الخيار القائم حاليا عبر ديمقراطية لا تحمل الهامش العريض لليبرالية وتوفر حدا من المشاركة دون التنازل عن مركزية رئيس الجمهورية (جمهورية رئاسة)، والخيارين على المستوى السياسي النظري هما موضوع أي حوار قادم، لكنهما على المستوى العملي يصعب فرضهما بشكل فاعل لسببين:
– إن مشروع الدولة المرنة لا يستند إلى قوة قادرة على فرضه، فهو مطروح من قبل أطراف معارضة بتحالفات إقليمية وبكتائب مسلحة على الأرض أقواها لا يؤمن بهذا الحل (داعش وجبهة النصرة)، وحتى الجبهة الاسلامية بطروحاتها الإيديلوجيا على لسان زهران علوش غير مقتنعة بديمقراطية تعددية تحت مظلة دولة مرنة (يمكن هنا مراجعة بيان الجبهة الإسلامية بعد تأسيسها).
– إن الدولة القائمة اليوم ستبقى ولفترة طويلة تعاني من صراع على محورين: الإرهاب من جهة، وانتزاع الشرعية إقليميا ودوليا من جهة أخرى، لذلك فإن الشكل الديمقراطي الذي تطرحه سيتجه أكثر نحو المركزية من أجل الحفاظ على بنية الدولة ولضرورات “الحرب على الارهاب”.
وتوضح التطورات أن الاحتمالات المفتوحة لتطور الحدث السوري ناجم عن عدم قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على تحديد أولويات استراتيجية في هذا الصراع، وهو ما يجعل انفجار العنف يخرج عن القدرة على التحكم، ولكنه في المقابل يطرح مجموعة من الحلول حول إعادة صياغة المنطقة، والتحكم بجغرافيتها السياسية، فهناك رغبة دولية جامحة لزج كافة عناصر المقوم السوري داخل الصراع، الأمر الذي يعقد الحلول ويقلل من إمكانية الخروج من الأزمة على مدى المنظور، وربما تصبح “الدولة” هي أساس هذا التحكم بالجغرافية – السياسية (إن لم تكن اصبحت بالفعل)، فتماسك الدولة الإقليمية انهار عمليا ولكن بدائل هذه الدولة لم تتوفر حتى اللحظة، ولن تستطيع النخب السياسية بمفردها الخروج من هذا المأزق، كما أن الدولة القائمة ربما تستطيع الصمود لفترة طويلة، لكنها غير قادرة على الخروج بمفردها من الأزمة، فهل هناك ضرورة لتحالفات داخلية جديدة؟!
أي تحالف لا يقوم على أساس مشروع جديد لا يمكن التعويل عليه، لأن “المشروع القائم” ليس مشروعا لدولة دينية أو جهادية فقط، بل هو أيضا صراع يبحث عن حل لانتهاء الدولة الإقليمية بشكلها السابق، وربما بمشروعيتها أيضا، وهي بالتالي تتطلب مشروعا بديلا منفتحا على الاحتمالات ولكنه متصلب تجاه عدم الرجوع عن خيار الدولة المعاصرة، فالمواجهه اليوم هي في النهاية تحد للمعاصرة في مواجهة الواقع الماضوي المفروض إقليميا لإعادة رسم المنطقة.
ما رأيك بهذه الدراسة ؟ و هل قدمت حلا عمليا للقضية المطروحة ؟ وما مدى قابليتها للتطبيق في المدى القريب ؟